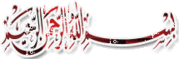
هذا المقال منقول ولكن النقل للافاده
الانبياء عليهم السلام هم أشرف الخلق وأزكاهم، وأتقاهم لله وأخشاهم، ومقامهم مقام
الاصطفاء والاجتباء، وواجب الخلق نحوهم التأسي والاقتداء
فالواجب أن يُحفظ لهم هذا المقام، وأن ينزهوا عن مد الألسن إليهم بالنقد والاتهام،
غير أن نفوسا قد غلبها الفسق، مدت ألسنتها إلى الأنبياء بالعيب والتهم،
فلم تدع نبيا - إلا ما ندر – لم ترمه بدعوى العيب والإثم، تريد بذلك
انتقاصهم، والحط من أقدارهم، بل والطعن في القرآن الكريم الذي ذكر عنهم
أحوالهم، فكان الذب عن أنبياء الله عز وجل متعينا، صونا لدين الله، وحفظا
لحق أنبيائه عليهم السلام
لكن قبل الخوض في تفاصيل رد ما رمي به الأنبياء عليهم السلام، نحب أن نبين أن
المقرر عند السلف أن الأنبياء عليهم السلام لا يتصور في حقهم الخطأ في مقام
الوحي والتبليغ، أما في غير ذلك من صغائر الذنوب مما ليس في فعله خسة ولا
دناءة، فإنه إن صدر من أحدهم شيء فإنه لا يقر عليه، بل يتبعه بالتوبة
والإنابة. وبهذا يبطل ما تعلل به الطاعنون من قولهم: كيف يجوز على الأنبياء
الخطأ وهم في مقام الأسوة والقدوة ؟ ونجيب على ذلك بالقول: إن الخوف من أن
يحصل اللبس في مقام التأسي بالأنبياء إنما يتصور فيما لو أخطؤوا، واستمروا
على الخطأ، ثم لم ينبهوا عليه، فيشتبه حينئذ على المقتدي الحال التي يجب
فيها متابعة النبي من الحال الأخرى، أما إن نبهوا على التقصير فلن يحصل
اشتباه، بل سيتحول المجال إلى مجال متابعة من وجه آخر، وهو المتابعة في حسن
الرجوع إلى الله سبحانه بالتوبة، وبهذا يسلم للأنبياء مقام القدوة
والأسوة، ويحصل لهم شرف التعبد لله عز وجل بالتوبة إليه سبحانه .
وقد تبين لنا من خلال بحثنا أن ما أورده الطاعنون في حق الأنبياء – بعد
استبعاد المكذوب عليهم - لا يخرج عن أن يكون سوء فهم للنص، أو أن يكون شيئا
وقع منهم قبل نبوتهم، أو أمرا فعلوه وكان على خلاف الأولى، أو خطأً تابوا
منه فتاب الله عليهم، فلا يحق لأي كان أن يتخذ ذلك ذريعة لانتقاصهم وثلمهم .
وقدفصلنا فيما يلي هذه الوجوه، وقررنّاها بأمثلتها حتى يتضح للقارئ الكريم أن
نتاج الدراسة الجادة لشبهات الطاعنين في الإسلام لن تكون إلا في صالح
الإسلام، وأن الحق لا يزيده طعن الطاعنين إلا ثباتا وظهوراً:
الوجه الأول : ما نسب إلى الأنبياء من مطاعن مبناها على سوء الفهم
من ذلك ما ادعوه في حق إبراهيم عليه السلام من أنه قد وقع في الشرك بادعائه ربوبية الكواكب، مستشهدين على ذلك بقوله تعالى:{ وكذلك
نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين * فلما جنَّ عليه
الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين * فلما رأى القمر
بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين
* فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني
بريء مما تشركون * إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من
المشركين }(الأنعام : 76-77)، والجواب على ذلك أن إبراهيم عليه
السلام إنما قال ما قال في مقام المناظرة والمخاصمة لقومه، إذ استعرض لهم
الكواكب شمسا وقمرا ونجما، وبين لهم بالدليل العقلي انتفاء الربوبية عنها،
ثم توجه إليهم مخاطبا إياهم بالنتيجة المنطقية لبطلان معبوداتهم فقال : { يا قوم إني بريء مما تشركون * إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين}.
فإن قيل: كيف يتأتى لإبراهيم عليه السلام مناظرة قومه في نفي ربوبية الكواكب
وهم إنما يعبدون أصناماً من الحجارة ؟ قلنا إن إبراهيم عليه السلام ناظرهم
في نفي ربوبية الكواكب حتى يتبين لهم انتفاء الربوبية عن آلهتهم التي
يعبدونها بطريق الأولى، وذلك أنه إذا تبين انتفاء ربوبية الكواكب وهي
الأكبر والأنفع للخلق، كان ذلك دليلا على انتفاء ربوبية ما دونها من
أصنامهم التي يعبدونها، لعظم الفارق بين الكواكب وبين أصنامهم التي يجهدون
في خدمتها دون أدنى نفع منها تجاههم .
ومن ذلك ما ادعوه في حق إبراهيم عليه السلام أيضاً من أنه شك في قدرة الله
سبحانه، حين سأله عن كيفية إحيائه الموتى، قالوا : والشك في قدرة الله كفر،
واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى:{ وإذ
قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن
قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم
ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم } ( البقرة : 260 ) ،
وأوردوا أيضا ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال :
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ( نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحي الموتى ، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) .
والجواب على ما أوردوه ببيان أن ما صدر عن إبراهيم عليه السلام لم يكن شكا في قدرة
الباري سبحانه، فهو لم يسأل قائلا: هل تستطيع يا رب أن تحيى الموتى؟ فيكون
سؤاله سؤال شك، وإنما سأل الله عز وجل عن كيفية إحيائه الموتى، والاستفهام
بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء متقرر الوجود عند السائل والمسؤول، لا عن
شيء مشكوك في وجوده أصلا، ولو كان السؤال سؤال شك في القدرة لكانت صيغته: "
هل تستطيع يا رب أن تحيى الموتى ؟ " وكيف يشك إبراهيم في قدرة الباري
سبحانه وهو الذي حاج النمرود بها، فقال: ربي الذي يحيى ويميت، وهو الذي
يأتي بالشمس من المشرق، فاستدل بعموم قدرة الباري على ربوبيته.
والسبب المحرّك لإبراهيم على طلب رؤية كيفية إحياء الموتى هو أنه عليه السلام
عندما حاجَّ النمرود قائلا: إن الله يحيى ويميت، ادعى النمرود هذا الأمر
لنفسه وأرى إبراهيم كيف يحيى ويميت، فأحب عليه السلام أن يرى ذلك من ربه
ليزداد يقينا، وليترقى في إيمانه من درجة يقين الخبر "علم اليقين" إلى درجة
يقين المشاهدة "عين اليقين"، وكما جاء في الحديث ( ليس الخبر كالمعاينة )
رواه أحمد .
قال الإمام القرطبي : "لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكاً في إحياء الله الموتى
قط وإنما طلب المعاينة، وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به "،
وقال الإمام الطبري : " .. مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى،
كانت ليرى عياناً ما كان عنده من علم ذلك خبراً " .
اما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( نحن أحق بالشك من إبراهيم ) فمعناه أنه
لو كان إبراهيم شاكاً لكنا نحن أحق بالشك منه، ونحن لا نشك فإبراهيم عليه
السلام أيضا لا يشك، فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام.
ومن أمثلة سوء فهم النص وتحميله ما لا يحتمل بغية الطعن في الأنبياء ما قاله
قوم من أن لوطا عليه السلام كان قليل التوكل على الله عز وجل معتمدا على
الأسباب اعتمادا كليا، واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى :{ بكم قال لو أني لي قوة أو آوي إلى ركن شديد }( هود: 80)، قالوا: والذي يدل على صحة فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على قوله ذاك، بقوله:( ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ) متفق عليه.
وجوابا على ذلك نقول لهم: إن هذا سوء فهم منكم للحال التي قال فيها لوط عليه
السلام ما قال، والسبب الذي حمله على ذلك القول ؟ فالأنبياء عليهم السلام
كانوا يُبعثون في منعة من أقوامهم، فيُبعث النبي من أشرف قبائل قومه
وأمنعهم، فتكون قبيلته - وإن لم تؤمن به - سندا له تحميه من كيد أعدائه
ومكرهم، كما قال تعالى عن شعيب { ولولا رهطك لرجمناك }(هود : 91)، وكما كان بنو هاشم للنبي صلى الله عليه وسلم حماة وسندا .
واما لوط عليه السلام فلم يبعث في قومه، وإنما بعث في مكان هجرته من أرض الشام،
فكان غريبا في القوم الذين بعث فيهم، إذ لم يكن له فيهم عشيرة، لذلك عندما
خاف عليه السلام أن يوقع قومه الفضيحة بأضيافه تمنى أن لو كان بين عشيرته
ليمنعوه، وهذا من باب طلب الأسباب، وهو طلب مشروع كما لا يخفى، لكن لما
كانت هذه الأسباب غير متوفرة، كان الأولى أن يتوجه العبد بطلب العون من
الله سبحانه، فهو المعين والناصر، ومن هنا جاء عتاب النبي صلى الله عليه
وسلم داعيا له بالمغفرة والرحمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ( يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد ) رواه البخاري ، وقال : ( ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ) رواه البخاري .
الوجه الثاني: ما نسب إلى الأنبياء من مطاعن وقعت منهم قبل النبوة
من ذلك ما ادعوه في حق آدم عليه السلام من أنه عصى وأزله الشيطان، قالوا والذي يدل على قولنا، قوله تعالى: { فَأَكَلاَ
مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا
مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } ( طه: 121) وقوله في الآية الأخرى:{ فأزلهما الشيطان عنها }(
البقرة : 36) والجواب على ما أورده هؤلاء أن ما وقع من آدم عليه السلام
كان قبل نبوته، فلا يصح أن يتخذ ذريعة للطعن فيه عليه السلام، قال الإمام
أبو بكر بن فورك:" كان هذا من آدم قبل النبوة، ودليل ذلك قوله تعالى : { ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
} فذكر أن الاجتباء والهداية كانا بعد العصيان، وإذا كان هذا قبل النبوة
فجائز عليهم الذنوب وجهاً واحداً، لأن قبل النبوة لا شرع علينا في تصديقهم،
فإذا بعثهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في الأداء معصومين لم يضر
ما قد سلف منهم من الذنوب".
فإن قيل كيف يقال: إن ما وقع من آدم عليه السلام كان قبل نبوته، أوَ ليست
النبوة هي الوحي من الله ؟ والله كان يكلم آدم قبل أن يخرجه من الجنة كما
تدل على ذلك الآيات والأحاديث، قلنا: النبوة المنفية هنا ليست هي مجرد
الوحي، وإنما هي الوحي إلى شخص النبي بشرع جديد أو بتجديد شرع سبقه، وهذا
ما لم تدل الأدلة على أن آدم أعطيه عندما كان في الجنة مع زوجته، فصح بذلك
القول بأن ما وقع منه عليه السلام كان قبل نبوته بالمعنى الخاص.
ومع أن ما وقع من آدم عليه السلام كان قبل نبوته إلا أنه أتبعه بالتوبة
والإنابة إليه سبحانه، وذلك لصفاء نفسه ومعرفته بمقام ربه، قال تعالى: { فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم }(البقرة:37).
ومن أمثلة ما أورده الطاعنون في حق الأنبياء عليهم السلام، وشنعوا به على
القرآن، وكان قبل النبوة ما أوردوه في حق موسى عليه السلام من أنه ارتكب
جريمة القتل، مستشهدين على ذلك بقوله تعالى:{ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد
فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على
الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو
مضل مبين }( القصص: 15) قالوا: وقد ندم موسى عليه السلام على هذه الجريمة،
ومنعه ندمه أن يتقدم بالشفاعة إلى رب العالمين، كما في حديث الشفاعة
الطويل :( فيأتون موسى،
فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس،
اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم
غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي، نفسي، نفسي ).
والجواب
على ما أورده هؤلاء الطاعنون في حق نبي الله موسى عليه السلام أن ما وقع
منه عليه السلام كان قبل نبوته، بدليل قوله تعالى: { قال
ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين * وفعلت فعلتك التي فعلت
وأنت من الكافرين * قال فعلتها إذا وأنا من الضالين * ففررت منكم لما خفتكم
فوهب لي رب حكما وجعلني من المرسلين } ( الشعراء : 18-21) ثم لم
يكن قصد موسى عليه السلام قتله، وإنما قصد دفعه عن أخيه، فقتله خطأ، وقد
استغفر موسى ربه من هذه الفعلة، فغفر له سبحانه، قال تعالى : { قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم } ( القصص : 16 ).
الوجه الثالث: ما نسب إلى الأنبياء من مطاعن وكانت في حقيقتها أمورا على خلاف الأولى
من ذلك ما ادعوه في حق نبي الله سليمان عليه السلام من أنه قعد يتفرج ويتمتع
بالنظر لخيوله حتى خرج وقت الصلاة، ثم عندما علم بتضييع وقت الصلاة بسبب
تلك الخيول قام بذبحها فكان في ذلك إهداراً للمال، وإزهاقاً لأرواح الخيل
في غير وجه حق، وزيادة تأخير للصلاة، قالوا والذي يدل على ما قلنا قوله
تعالى:{ ووهبنا لداوود سليمان نعم
العبد إنه أواب * إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد * فقال إني أحببت حب
الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب * ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق
والأعناق } ( ص : 30-33 ).
وجواباً
على ذلك نقول: إنه ليس في الآيات - محل البحث - تصريح بأن سليمان عليه
السلام قد ضيع الصلاة الواجبة، والتصريح الذي في الآيات هو أن الخيل قد
شغلته عن ذكر الله، وهنا يحتمل أن يكون المراد بذكر الله الصلاة المفروضة،
ويحتمل أن يكون المراد بها صلاة النافلة، أو الذكر، وعلى أي احتمال فليس في
الآية أنه - عليه السلام - ترك الذكر متعمدا، بل ظاهرها أنه نسي ذكر ربه
باشتغاله بأمر الخيل .
وكذلك
ليس في الآية تصريح بأن سليمان ذبح الخيل وأزهق أرواحها ورماها عبثا،
وإنما في الآية التصريح بأنه مسح سوقها وأعناقها، وقد قال بعض المفسرين أنه
مسح الغبار عنها حبا فيها، ومن قال: "ذبحها" لم يقل رمى لحمها، والظن به
عليه السلام إذا ذبحها أن يتصدق بلحمها، إذ في ذبحها والتصدق بلحمها ما
يكون أرضى للرب سبحانه، فكأنه عليه السلام يقول لربه سبحانه: هذه التي
شغلتني عن ذكرك ذبحتها لك، وتصدقت بها على عبادك.
وبهذا يتبين أن ما وقع من سليمان عليه السلام من اشتغاله بالخيل عن ذكر الله
إنما هو خلاف الأولى، وليس من باب المعاصي والآثام، بل هو من ربما كان من
باب النسيان الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان .
هذا بعض ما أورده الطاعنون في حق الأنبياء عليهم السلام، وقد أجبنا عنه بما لا
نزعم أنه لا مزيد عليه، ولكننا نحسب أننا فتحنا أبوابا للحق، تضيء بنورها
ظلمات الباطل فتزيلها، وينبغي للمسلم إذا عرضت له شبهة من الشبهات تجاه
أنبياء الله ودينه أن يواجهها بالحجة والبرهان فيبحث في مظان كتب أهل
العلم، ويسأل المختصين، عملا بقوله تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }(النحل: 43)